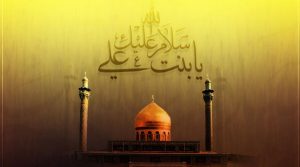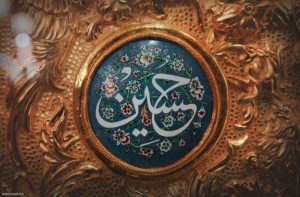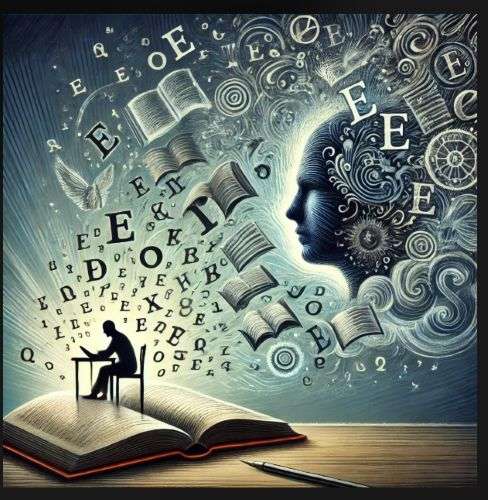
بقلم الدكتورة مواهب صالح مهدي – كلية العلوم الاسلامية – جامعة كربلاء
مقاربة التاريخية لموت المؤلف:
ترتد فكرة موت المؤلف إلى جذور فلسفية وفكرية ترتبط بالظروف الموضوعية التي عاشتها ارويا بعد ثوراتها على الكنيسة، فقط أعلن الفيلسوف الوجودي نيتشه مقولة: موت الإله. ووجدت هذه المقولة صدى واسعا في لأوساط النقاد الأوربيين الذين يتوقون إلى تدمير الاتجاه الغيبي في تفسير النصوص وإفساح الطريق أمام ظهور الإنسان بكل مقدراته البشرية التي يدركها العقل وما عدا ذلك فهو ميت.
بعدها انتقلت مقولة موت الإله إلى النقد الأدبي، فأعلن النقاد الغربيون وعلى رأسهم رولان بارت(1915. 1985 واحدا من أهم أعلام النقد)عن موت المؤلف وقد أكد بارت نفسه أن عددا من النقاد الأوربيون قد سبقوه إلى مقولة موت المؤلف مثل: الأديب الفرنسي مارليه الذي كان من أوائل المتنبئين بضرورة إحلال اللغة ذاتها محل من كان مالكا لها أي المؤلف، لأن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف حسب مارليه.وكذلك أشار بارت إلى جهود بول فاليري حيث يضع المؤلف موضع سخرية وأن اللجوء إلى دواخله خرافة ولابد من التركيز على البنية اللغوية لعلم المؤلف وإقصائه منها.
كما استفاد بارت من جهود العلم الغوي السويسري فاردينون دي سوسور الذي نظر إلى النص باعتباره شبكة من عناصر الاتصال اللغوية، ولذلك فإن خير وسيلة لمقاربة هذا النص هي الانطلاق من مصدره اللغوي أي من بنيته الداخلية بهدف استكشاف الأنظمة أو العلاقات التي تشكل دلالاته بمعنى أن حركة التحليل البنيوي نتيجة من داخل النص إلى خارجه، وليس من خارجه المتمثل: في المؤلف، السياق، العصر أي الزمان، البيئة([1]).
التعريف بنظرية موت المؤلف:
هي لا تعني إلغاء المؤلف وحذفه من الذاكرة، غنما تهدف إلى تحرير النص من سلطة الطرف المتمثل بالأب المهيمن أي المؤلف، إنها تفتح النص للقارئ، بما أن القارئ هدف أولي للنص، بحيث تزيح المؤلف مؤقتا إلى أن يمتلئ النص بقارئه، والقارئ بالنص، ثم يصار بعد ذلك إلى استدعاء المؤلف لحضر حفلة زفاف النص إلى قارئه لبارك هذه العلاقة الجديدة، وينظر الولادة الآتية فرحا لأبنه.
وموت المؤلف إذن ليس فناءه ولا نهايته بل هو فحسب ترقيع للنص عن شروط الظرفية وقيودها، ومن ثم فتح المجال لنصوصية النص لكي يدخل الأخير إلى أفاق إنسانية عابرة للزمان والمكان، حيث يكون للنص أن يأخذ مداه مع القارئ ومع التاريخ، معناه الاستقلال عن سلطة المؤلف([2])
على أن المؤلف الأكبر للنص هو الموروث الذي يشكله سياقا مصدريا ومرجعيا للنص مثلما شكل أساسا لفهم النص وتفسيره بعد أن كان مصدرا لإنتاجه وحدوثه، وهنا يوجه الانتباه إلى علاقات التبادل ما بين النص كإبداع ذاتي والموروث كعطاء ماثل ذي وجود سابق على النص ولاحق به ومحيط بكل تحولاته.
وقد ذكر بارت في مقاله: النقد والحقيقة الذي صدر عام 1966م، أن نمط النقد الذي يؤكد العلاقة بين النص والمؤلف قد انتهى وهناك نوع جديد من التحليل.
ثم وضع بارت مبررات مقولة موت المؤلف بقوله: إن نسبة النص إلى مؤلفه معناها إيقاف النص وحصره وإعطاؤه مدلولا نهائيا، إنها إغلاق الكتابة.
ارتبط اسم الناقد والكاتب الفرنسي رولان بارت بحركة النقد البنيوية التي كانت سائدة في تلك الفترة الزمنية فتميزت اغلب إعماله الأدبية بالتنوع الشديد والتناثر في اغلب ميادين اللغة والنقد الأدبي والتي تقع في مجملها في خمسة عشرة مؤلفا أصبحت معروفة لدى القارئ العربي منها اللغة ،خطاب عاشق ،ولذة النص والكتابة في درجة الصفر([3])
([1])محمد فتاح، مرجع سابق: 66.
([2])مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت 1974م، ص: 6
([3])]. رولان بارث: نقد وحقيقة.ترجمة: د.منذر عياشي، ط 1، دار الأرض، الرياض، ط 1، 1995، ص:25